مجموعة المسرح ثقافة .. تجدد مستمر .. وعطاء مثمر .. حوار الأسبوع : سقف الرقابة الكتابية .. التأليف المسرحي أنموذجاً
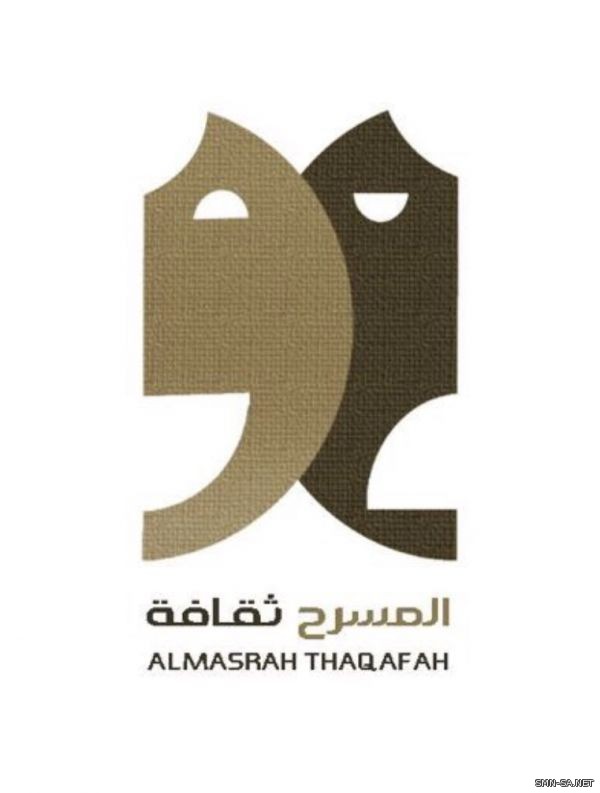
12-06-2017 05:25 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-سماء الشريف تتعدد برامج مجموعة المسرح ثقافة والتي استطاعت من خلال برامجها ونقاشها الأسبوعي استقطاب الكثير من كبار المسرحيين والإعلاميين والمثقفين بصورة عامة من داخل السعودية وخارجها وهي مجموعة واتس اب أسسها الممثل والمخرج السعودي سامي الزهراني لتكون منصة متميزة جادة وجاذبة من خلال استخدام أدوات التواصل الحديثة تعمل على جذب المسرحيين بماتقدمه من برامج متنوعة من ثقافة مسرحية ونقاش متنوع .
وقد كان للمجموعة نقاش في برنامج الحوار المحدد لهذا الأسبوع حول ؛ "سقف الرقابة الكتابية .. التأليف المسرحي انموذجاً "
المشاركون في الحوار :
- الاستاذ الدكتور سيد علي اسماعيل من مصر .
- الناقد المصري د.محمود سعيد مشرف المجموعة .
- الناقده والكاتبه العمانية د.آمنه الربيع .
- مؤسس المجموعه المسرحي السعودي سامي الزهراني .
- الناقده المصريه د. لمياء أنور .
- المسرحي السوري د. عجاج سليم .
- المسرحي العراقي د. أحمد الشرجي .
- المسرحي السعودي عباس الحايك .
- الاعلاميه السعودية سماء الشريف مشرفه المجموعة .
- المسرحي العراقي د. جبار خماط .
- المسرحي السوري كنعان البني.
- المسرحي العراقي فرحان هادي .
- المسرحي السعودي حسن الخلف .
- المسرحي المغربي المختار العسري .
- المسرحي المغربي عزيز ريان .
- المسرحي الجزائري د.سوالمي الحبيب .
 أدارت الحوار مشرفة المجموعة الإعلامية غادة كمال
أدارت الحوار مشرفة المجموعة الإعلامية غادة كمال
بداية المداخلات انطلقت من مداخلة الناقد المصري د. محمود سعيد الذي يرى أن :
الرقيب العربي لازال يمتلك عقلية غريبة قادرة علي الإثارة والدهشه والصدمه لدرجه اننا أصبحنا نحيا مرحلة المصادر ة والمنع وكأنها أصبحت
شهوة المنع والمصادرة لدرجه أن تحولت المصادره إلى داء عربي مزمن يصعب علاجه
ومن جانب آخر يرى أن الرقابه بكل أشكالها كانت وما زالت تعبيرا عن السلطه السياسيه مع ان المفروض ان تكون هي السلطه الثقافيه والفنيه التي تحكم الرقابه لا غيرها محدداً أنها ( فرضيه شديده الخصوصيه و الأهميه )
ويفسر رأيه في ذلك : "من العبث اننا نجد الرقابه لها دور قبل العمل وبعد تنفيذه بمعنى ان قرارات الرقابه قبل تنفيذ العمل في وادي وبعد العرض في وادي آخر"
مؤكداً أن : الرقابه باقية ما بقي المبدع ولكن :
العلاقه بين الرقيب والمبدع ستظل علاقه يشوبها اللغط وعدم الوعي خاصه ان الرقيب في الاغلب لا يكون فناناً أو حتى ممارس للفن لذا يطبق قوانين جامده بلا وعي أو روح أو حس
ويؤكد على أن الرقابه الذاتيه من المبدع ذاته حين يتحول المبدع الي رقيب على عمله
وعند الوصول لتلك المرحله بشكل صادق لن تكون هناك حاجة الى رقيب
وقد يلعب الناقد دور الرقيب في شكله السليم لو أجاد لعبته واتقن مفردات اللعبه المسرحية.
أما الدكتور سيد علي إسماعيل فيرى أن الموضوع مهم جداً بالنسبة له حيث أنه :
صاحب أول كتاب عربي في مجال الرقابة المسرحية وصدر من 20 سنة.. ولذلك أرفق رابطه ليكون فرصة ليطلع عليه الجميع :
رابط تحميله كاملا مشاركة مني في الموضوع
http://kenanaonline.com/users/sayed...ownloads/77276
الناقدة المصرية الدكتورة لمياء انور ترى أن الموضوع هام جدااا وشائك :
معللة ذلك : بأننا لسنا امام ظاهرة او قضية بقدر ما نحن عليه اليوم من ممارسات في اغلب الاحيان غير حيادية وغير موضوعية
وقد وجدت أن الرقابة للرقابة على ثلاث اشياء في العملية الابداعية وهما الدين والجنس والسياسة ، لذا جاءت الرقابة بمفهوم المنع وفي بعض الاحيان البتر لجزء من العمل الفنى دون الوعى بسير العملية الفنية لذا جاءت الرقابة لخدمة اهداف سياسية بالمقام الاول بعيدا عن الابداع في حد ذاته ومن هنا اصبحت علاقة الرقيب بالمبدع علاقة ادارية بحته الاول ينفذ دون وعى و الاخر تمارس عليه ضغوطا ليس لها علاقة بالفن
ومن ذلك ترى ؛ أن الرقابة ليس لها دور في اطار العمليه الفنية خاصة انها لا تناقش -مثلا -مايتناولة العمل الفنى من نظريات او اتجاهات حداثية او غيرها .....
وتتساءل من خلال ذلك :كيف يمكن المطالبة باعمال فنية وابداعية في ظل الرقيب والمنع والشجب.
مطالبة إطلاق العنان للفنان لأفكاره وتجاربه لإنتاج عمل فني ، وهناك العديد من النقاد لديهم القدرة لانتقاد العمل الفني بعد إنتاجه وبشكل علمى وأكاديمي واحترافي أيضا بعيداً عن سلطة الرقابة والرقيب.
ثم كانت مداخلة د. آمنة الربيع من عُمان التي تدور حول الرقابة.. كتبت متناولة تاريخ الحذف في ثلاث نقاط :
(1) الرقابة تتطور عبر العصور، بينما قانون المطبوعات والنشر لا يتطور.
كتبت عن تجربتها الخاصة سطوراً جاء فيها :
" لي مع الرقابة علاقة قديمة ومتفاوتة بدأت برفض نشر بعض مقالاتي في الصحافة في بداية الثمانينيات، ثم هدأ الوضع، وعاد المنع وتجدد بعد أحداث 2011م والاعتقالات التي طالت بعض المثقفين وغيرهم. لكن التدخل الكبير والأخطر هو التدخل في سير خطوط مسرحياتي، كأن تكتب لجنة القراءة والتقييم في تقريرها ملاحظات تطلب فيها تغيير عنوان مسرحية وتغيير أسماء بعض الشخصيات ذات الدلالات الدينية، وكان آخرها مسرحية (المعراج) لقد أزعجتني ملاحظات لجنة القراءة لأنها وضعتني وطبق عجة البيض في كيس واحد! وربما تدّعي هذه اللجنة وسواها أنها لا تمارس دورا رقابيا، وهذه إحدى دفوعاتها، لكن من يستطيع أن يجزم أن تقريرها لا يُعد وثيقة رقابية، طالما طلبوا فيه فعل (الحذف) ؟
وما يُعنيني هنا، أن تاريخ الحذف عريق وسحيق. ولكنه على كل الأحوال ليس أعرق من تاريخ الرقابة!
حسنا، كلكم تعرفون عظمة الملكة إليزابيث التاريخية، هل تتخيلون أن تلك العظمة يمكن أن يزحزها أو يُربكها أو يُقلقها مشهد مسرحي!!
يذكر يان كوت في كتابه شكسبير معاصرنا أن جميع طبعات مسرحية الملك ريتشارد الثاني إبّان حياة الملكة إليزابيث قد حَذفت مشهد التنازل عن العرش لأن المشهد على حد قوله (يكشف بفظاعة زائدة كيفية العمل في الآلة الكبرى، في تلك اللحظة بالذات التي كانت السلطة فيها تنتقل من يد إلى يد)! وهكذا جرى حذف المشهد وقياس فظاعته بعظمة الملكة إليزابيث!!
كيف نستطيع أن نتعرف على أشكال الحذف البشعة للنصوص التي مر بها التاريخ منذ عصر شكسبير وإلى اليوم؟ ليس حصريا في المسرح، بل وفي جميع وسائل التعبير الأدبية والفنية المتاحة. يبدو الجواب في غاية الصعوبة؛ لسبب وجيه يتمثل في أن فكرة الرقابة نفسها قد تطورت عبر العصور وفي جميع الحضارات الحية، وذلك انطلاقا من قاعدة أن الممنوع مرغوب، وكلما تطور الممنوع في مجتمع ما تطورت الرقابة، لأن الممنوع ينتعش على حاشية المسكوت عنه" .
وأكملت مداخلتها بالنقطة الثانية التي كتبت فيها عن العلاقة الطردية بين الأدب والرقابة والحذف :
(2) هناك عصافير تذهب تبحث عن أقفاص.
أن العلاقة بين الأدب والرقابة والحذف علاقة طردية. فكلما زادت جرعة الحرية في مجتمع ما (وهي عموما لا تزيد لكن هكذا نوهم أنفسنا) كلما ارتفعت حدة صوت الرقابة وقيودها وتطاولت ألسنتها. قد تنتشر وشاية من أحد أصدقاء مؤلف/ مؤلفة الكتاب، أو من المؤلف نفسه أن المخطوط يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، ووصول الوشاية إلى الجهة الرسمية كاف لمصادرة المخطوط تأديبًا لصاحبه! فيتم مصادرة المخطوط والمؤلف/المؤلفة يجدان ضالتهما في نشره بطبعات غير قانونية، أو في خارج الدولة، أو على المدونات الشخصية، فترتفع بذلك قيمة رصيدهما في سوق الكتاب، في حين أن مضمون المخطوط نفسه قد لا يساوي جناح بعوضة! فتتحقق شهرة المؤلف/ المؤلفة من حيث لا تتوقع الرقابة.
*في النقطة الثالثة والأخيرة كتبت عن :
(3) مفهوم الدولة والرقابة بمثابة قفص يبحث عن عصافير.
تاريخيًا يرتبط تاريخ الرقابة السيئ والحذف بتاريخ الاستيطان للبلاد العربية. ولكنه عربيا يعود إلى أزمان سحيقة أخرى. وتعلو سلطة الدولة فوق الجميع. فمن المرجح أنه كلما تعلقت المادة الإبداعية بالثالوث (الدولة والجنس والدين) أو أشارت إلى أحدهما أو ألمحت لمحة خفيفة كلما اختلفت الآراء بين صاحب المادة الإبداعية مع الجهة الرقابية من جهة، ومع القراء من جهة أخرى، فيصير القارئ رقيبا وقاضيا وكذلك الكاتب/ المبدع يتحول إلى رقيب مضاعف. إن مجرّد تفكير المؤلف بكتابة عمل أدبي يقترب من الثالوث يُعد بمثابة الخيانة.
الناظر إلى العلاقة التسلطية بين الدولة والرقابة يظهر له أن مفهوم الدولة أحيانا أكثر هشاشة وأقل تماسكا من مفهوم الرقابة. وإذا كانت المهمة الأساسية للدولة عند ماكيافيلي هي "الأمن لا الأخلاق والحرية"، فإنّ الفيلسوف هيجل ذهب إلى القول بأن "الدولة ضرورة أخلاقية وتجسيد للحرية"، بينما قال ماركس بأنها "أداة قمع ومصادرة للحرية، هدفها الحفاظ على الامتيازات القائمة للطبقة الحاكمة على حساب الأغلبية المحكومة المعدمة". أما الرقابة نقلا عن ماريو إنفليزي في كتابه الكتب الممنوعة فتعتبر "حكمة سياسية بالغة، وانعكاسا ودرعا لكل حكومة جيدة"، فأيهما يسبق الآخر: الدولة أو الرقابة؟ وأيهما يتطور أكثر وأسرع: الرقابة أو الدولة ؟ .
من جانب آخر كتب د.أحمد شرجي من العراق مداخلته عن المحرمات الثلاث :
"التابوهات الثلاث او المحرمات الثلاث والتي معمول بها في اغلب بلداننا العربية، ويمثلن جوهر وجود الرقيب، ولجنة الرقابة تعتمد ذائقتها كما هي لجان التحكيم في المهرجان، وهذا الوجود يكون محفّزا ومقرفا في ذلت الوقت، محفز اذا كان واعيا وذو عقلية واعية وعالية المهنية منا تساهم ملاحظاته بتطوير النص وإيجاد وسائل تعبيرية ورمزية يفتح بها باب التأويل على مصراعيه، ومقرف عندما يكون ليس له علاقة بالموضوع وفرض وجوده داخل اللجنة كطرف أمني او حزبي ويكتب تقريره عن النص والعمل، اذكر في العراق في زمن النظام السابق كان هناك شخص أمني يجلس داخل البروفات ويكتب تقاريره عن كل مايدور داخلها....لكن السؤال الجوهري ما جدوى وجود التابوهات الثلاث( الدين، السياسة، الجنس) ونحن نتحدث عنها بيومياتنا وأحاديثنا العامة احيانا، المسرح بدء احتفاء بالجسد، واوربا تطورت عندما فصلت الدين عن الدولة، التجربة الان في المسرح العراقي اكثر صعوبة، لعدم وجود اي رقيب سوى الرقيب الفني على مستوى العمل، ولعدم وجود التابوهات الثلاث كما في مسرحية يارب وستربتيز، زادت من صعوبة الموضوعة وكيفية معالجتها برؤية تبتعد عن المباشرة والتسطيح على المستوى اللفظي والبصري ، الفنان ليس ملح، ولا داعر ولا خطيب سياسي، الفنان مشاكس ومحرض لكل هؤلاء بطريقة جمالية بعيدة عن الاسفاف.
وحدد د. شرحي أن ماكتبه من واقع تجربة شخصية حين كتب مؤكداً : " اتحدث عن تجربة شخصية، في زمن النظام السابق، يرفض النص وتكتب عبارة ( غير صالح من ناحية السلامة الفكرية) وهذه العبارة حمالة أوجه ، ومازلت للان احتفظ بالنص ومكتوب عليه تقرير اللجنة ، بعد ٢٠٠٣ وبعد عودتي للعراق كنت ضمن لجنة المشاهدة في دائرة السينما والمسرح، رفضنا اكثر من عرض على المشاهدة من الناحية الفنية فقط، لسنا معنين بخطاب العرض الفكري فهذا خيار المخرج، وكنا نستدعي المخرج لوحده في قاعة اخرى ونتحدث أمامه بكل الملاحظات حتى لا نحرجه اما فريقه، بعضهم يرفض الملاحظات ولا يقبل التدخل بعمله، والبعض يأخذ ويتفق مع ملاحظات اللجنة ، وكما قلت في مداخلتي بان اللجنة كما لجان تحكيم تعتمد ذائقة أشخاص ، ولهذا اسميناها لجنة المشاهدة ومهمتها الرئيسة الجانب الفني فقط
لجنة المشاهدة، ونعمل تحت هذا العنوان لتقويم العمل الفني فقط، الاداء، الاخراج، التعامل مع النص، السينغرافيا وتوظيفها، اي، عيون اخرى مثقفة ومدربة من خارج التجربة قبل عرضها للجمهور، بالمناسبة هذه موجودة في أوربا ويسمى عرض تجريبي قبل الافتتاح الرسمي بأسبوع او اكثر ويكون الحضور بدعوات خاصة للصحافة ومن يختارهم المخرج، ويعطون ملاحظاتهم عن العمل.. وهذه ظاهرة صحية للارتقاء بالعمل المسرحي"
ويرى في ذلك أن : المشكلة الرئيسة عدم إجادة فن الحوار حتى اغلب من يدعون ذلك، يرى ما يطرحه هو الأصح دائما ، ويتهم الآخر بالجهل والفشل وعدم المعرفة إذا لم يتفق معه بالراي، ويرفض الحوار المعرفي .
وختم مداخلته بسؤال مما يحدث في كل ما أورد:
( وإلا فماذا نسمي هذا التخبط على مستوى التنظير والمصطلحات؟ )
المسرحي السعودي حسن الخلف يرى أن :
الرقابه بحد ذاتها تحتاج لرقابه ويعتقد أن الاعلام الرقابي لو أتيت بنص لفسحه ويتم فسحه رقابيا للعرض او النشر وبعد فترة وجيزة تأتي بنفس النص ولكن بعنوان آخر يتم فسحه بالعنوان الجديد وبكاتب جديد
الدكتور عجاج سليم من سوريا ينظر من زاوية أخرى حيث يستغرب من بدء النقاش باعتبار بدهية الرقابة :
يبدو أننا بدأنا النقاش وكأن وجود الرقيب مسألة بدهية في حياتنا الفنية والفكرية. لننطق أولا أن وجود الرقابة بالمعنى الموظف الإداري هو أمر غير طبيعي. لأن الإبداع دائما لا يصدر إلا عن روح حرة مشاكس تبغى كسر المألوف والتقليدية والعادية.
والإبداع رفيق التجديد والتجريب. الإبداع لا يعيش في الماضي. ولا يخضع لسلطة ..أي سلطة .
المبدع يعيش في بيئته ويعرف كل تفاصيل حياتها...وهو ضميره الحي. ..لذلك وجود رقيب غير الرقابة الذاتية التي تدرك حجم وسعة الفضاء الذي تعيش فيه..هو إهانة للكائن الحي الذي نطلق عليه اسم فنان أو مفكر.
الرقابة التي عانت منها اوربا في العصور الوسطى جعلت الانفجار والرفض عند المبدعين بحجم ثورة عالمية.
ونعرف نحن في الشرق نعاني وخاصة في المسرح نعيش رهاب الرقابة ونخصع لها...بإرادته أو غصب عنا. وهي لم تعد تقتصر على رقابة الموظف قاصر الرؤية. بل صرنا نخضع للرقابة الدينية ورقابة المجتمع...لذلك نحن ندور طولة في فنجان منذ قرون طويلة.
نحن ضحايا الخوف الذي زرعته أنظمة لا تحترم الفرد وعلى مستوى الشرق. وازعم أنني لا استثني. ..أحدا في الشرق.
الرقابة حالة قصور إنساني وعائق إبداعي تقف كالسد في وجه حرية الإبداع.
لا نستطيع تجاوزها حاليا ومباشرة .ولكننا نستطيع أن نتجاوزها بذكاء لا يستطيع الرقيب الموظف المتحجر.
بريخت استنكر أن يكون الشرطي الرقيب أذكى من الفنان المبدع...أي أن يكون قادرا على القبض على أفكار تسعى للحرية والعدالة واحترام الإنسان الفرد.
وقد اتخذ من مجموعة المسرح ثقافة مثلاً حين حدد ها ليدعم رأيه الذي حدده فيما كتب : "هنا في المجموعة الثقافية نحن نعيش مثل هذا المثال ولن يكون الرقيب ابرع منا في رغبتنا المستمرة لنشر وتبادل الأفكار .
الكاتب المسرحي السعودي عباس الحايك يرى أن علاقة الكاتب بالرقابة بطبيعتها علاقة ملتبسة :
وليست علاقة الكاتب المسرحي وحده، بل كل من يمارس شكلاً من أشكال التعبير أدباً كان أو فناً، ولنقل أكثر هي ملتبسة مع كل مبدأ وصاية، فالإنسان بطبيعته ينفر من الوصايات، ويتوق للتحرك بحرية دون عوائق.
الكاتب المسرحي بطبيعته ميال لأن يكتب بحرية مطلقة، يطرق ما يشاء من موضوعات دون وجل ودون وصاية أحد عليه، مع هذا فإن ثمة رقابة داخلية تبنيها الطبيعة الاجتماعية أو الانتماء لجماعة ما أو طبقة ما، أو حتى وجود ما. ثمة التزامات تنبني في اللاوعي وتتحول لوصاية لذاتية، أو لنقل رقابة ذاتية لا تحتاج لأي وصاية خارجية. لذا لا يجد الكاتب مطلق الحرية في الكتابة فثمة ما يعلق في ذهنه عن خطوط حمراء اجتماعية ودينية وأخلاقية تمنعه من الانطلاق.
المشكلة في الرقيب الخارجي الذي يتطرف في بعض الظروف تجاه هذا الكاتب ويمارس وصاية أشبه بقمع أفكار الكاتب ويحد من حريته حتى في الموضوعات التي يقاربها في نصوصه، وهذا وفقاً للمكان ووفقاً لطبيعة هذا الرقيب. وبطبيعة الحال سيحد هذا من إبداعات الكاتب لأنه سيجد نفسه في دائرة مغلقة وفي موضوعات محدودة يمكنه تناولها ولن يتمكن من تجاوز تابوهات الرقيب.
الجيد أن الرقيب العربي مثلاً ليس واحداً، ولا يستند لنفس المعايير، فما هو ممنوع في بلد قد يكون مسموحاً في آخر، العكس صحيح. فيمكن تمرير نص بسهولة في بلد ما بينما يتعثر هذا النص أماما مقص الرقيب فيمنع عرضه. لذا فإن على الكاتب في الوقت الحالي حين يكتب نصاً ملامساً لموضوعات حساسة فإنه يمكنه إخراج نصه من عقبة العرض بنشره على شبكة الانترنت ليجد طريقه على الخشبة في مكان ما حيث يكون الرقيب يعمل ضمن معايير أقل تعقيداً. وإن كان نشر النص محفوف بالمغامرة، في وقت أصبح المخرجون ينفذون النصوص التي يقرأونها من على الشبكة دون العودة للكاتب والحصول على موافقته.
لن تنتهي هذه العلاقة إلى خير دون أن يتخفف الرقيب من تطرفه تجاه ما تطرحه النصوص المسرحية، فالنص المسرحي مهما كانت محمولاته لا يمكنه أن يكون مؤثراً بالقدر التي تؤثر فيه وسائل التواصل المفتوحة والفضاء الافتراضي الذي لم يعد قادراُ على أي رقيب منع ما فيه. النص المسرحي بطبيعته نص إبداعي كاشف ولا يمكن أن يخاف منه كمحرض ليتعامل الرقيب معه بريبة.
الدكتور جبار خماط من العراق يرى أن الرقابة والإبداع لايلتقيان والسبب في ذلك :
أنهما حدي نقيض في الانتاج والتاثير ، تؤدي الرقابة السياسية او العرفية او الدينية او الاجتماعي ، الى نكوص ابداعي تعلو في الذاتية المعزولة عن حركة المجتمع ومتطلباته ، وثمة نتاج ادبي او فني ، يتمرد على الرقابة بالاستعارة الفنية الرمزية ، وهنا تكون رسالة الفن فوقية ونخبوية لا يتواصل مع الجميع ، ان الفن بذاته ، انساني القصد بوساطة الجمال الفعال المؤثر الخال من المؤثرات المقيدة للحركة الابداعية داخل العرض المسرحي المعافى تكوينا وتاثيرا ، فعلا الراقابة مازق كبير في بيئة تتطلب حرية كافية ومشروطة بالابداع الفني .
كما يرى أنه لا توجد رقابة ذاتية على الابداع ، لأنه طاقة ذهنية ابتكارية تتجاوز قيود الزمان والمكان بوصفها حدين تجرببين ، كما يقول الفيلسوف كانت ، بانه كيف له حدوده الخاصة ، وبالتالي لا توجد رقابة ذاتية ، لانها بمثابة قيد إضافي للقيود المفروضة على التجربة الفنية من الخارج ، ولنعلم ان الفن طاقة خلاقة لها خاصية الفرادة التي من ميزاتها الفرادة ، وهي لا تريد من المبدع رقابة ذاتية .
المسرحي عزيز ريان من المغرب تطرق إلى الرقابة بالمغرب التي يرى أنها تغيرت بشكل كبير :
ممثلاً لذلك بفترة التسعينات حين كانت فرقة مسرحية هاوية تتعرض لمضايقات عدة في اختيار النص حيث المقدم (عون سلطة أو ما يعرف بالشام بالمختار) هو من يؤشر على نص أو لا. فكان لزاما البحث عن اليات لللعب على الرمزية والابتعاد عن المباشرة.
فليس هناك هيئة خاصة بالرقابة بشكل رسمي كما بمصر مثلا لكن يمكن الضغط أو التضييق في ترويج وعروض النص أو المسرحية. فنشر نص مسرحي مثلا لا يمر برقابة رسمية تطالعه وتقبله أو ترفضه! لكن لو مَس (مقدسات) المملكة المحددة بالدستور سيتعرض صاحب النص لعقوبات زجرية! الا ان أسوأ رقابة هي رقابة المجتمع الذي قد يحاكم عرضا بشكل عادات أو تقاليد سبقت ويهاجمه بكل الطرق فقط لانه تجرأ وتعرض المسكوت عنه فلا يحاكم فنيا بل (اخلاقيا ) كما جرى مع عرض(ديالي) للمخرجة نعيمة زيطان!
متسائلاً :كيف سيتم تنظيم مجال الرقابة بالمغرب في مجال المسرح الذي لازال ينقش في الصخر طريقه؟
وكيف تراقب المنتجات الفنية وعلى اَي أساس ؟ فني؟ علمي؟ اجتماعي؟ نفسي؟ اخلاقي؟ ديني؟!!!!
ويؤكد من خلال ذلك : ان الكاتب ببلده يقوم بعملية رقابة ذاتية حيث يكتب وهو يستحضر ما هو ممنوع أو مجاز وهذا طبعا تضييق على حرية الإبداع ولا يعني ان قبول الاسفاف وماشابه لكن لابد من تقبل ماهو جديد وماهو صادم باعتبار قيمة المسرح التي تشارك قسرا في التغيير والتقدم.
كما يرى أن الثقافة لازالت كما في اغلب الدول العربية تعتبر زائدة دودية تم وراثتها من الماضي ولا ينظر اليها بشكل جدي وقيم وخصوصا فن المسرح الذي يعتبر فن تسلية ليس إلا.
ويختم مداخلته مؤكداً على ضرورة مناقشة الموضوع بين المهتمين وذلك لكي يقوم المسرحي نفسه برقابة منتوج المسرح بوازع فني وراقي أكثر ! .
المسرحي العراقي فرحان هادي كتب عن الرقابة في وطننا العربي حيث يرى أنها دائمة الاهتمام بالجانب السياسي :
ممثلاً لذلك بسؤال : هل يقصد المؤلف حكومة البلد أم يحاول المساس بالدين الحنيف دون النظر للأمور الفنية والإبداعية .. !
ومع ذلك لايرى مانعاً من نقد المؤلف حكومته ومسئوليه إذا قصد بذلك توجيها مباشرا أو غير مباشر ؟!..
مؤكداً أنه من تجاربه مع الرقابة :اهتمامهم بهذه النواحي مع الأسف الشديد وفي أحيان أخرى يفهمون المحتوى حسب رؤيتهم وفكرهم دون محاورة الكاتب .. موضحاً ذلك بمثال خاص حين قدم عملا للأطفال في بلد عربي وهو يحث على الاهتمام بالعلم وفي سياق العمل أن من يحكمهم لايحترم العلم والعلماء ولكنة حينما يمر بظرف مأساوي ولم يجد حلا إلا عند العلماء .. بعد ذلك يوصي بالإهتمام في العلم والعلماء .. قامت اللجنة برفض النص لأنه يمس الحاكم لهذه الدولة !!
ويؤكد في سياق مداخلته أنه ضد الرقابة ولكن بشرط أن تناقش المؤلف وليس المخرج فربما يقنعهم أو يقنعوه -الموضوع طويل وشائك - والرقابة الذاتية تحتاج لمؤلف صاحب ضمير حي ويحترم مهنته .. ولكن يوجد الكثير في وقتنا الحالي يكتبون للكسب المادي ...
ثم يختتم مداخلته حين يرى أن : النقاش مع المؤلف مهم وهنا حتى يتوضح للرقابة أيضا مايحمله هذا المؤلف من فكر نير .. ولكن نسينا أيضا أن ليس كل رقيب أيضا هو مهني .. هي إشكالية وكأن الهدف البحث عن المثالية بكل شيئ ومن وجهة نظره يرى أن الفن يجب أن تكون رسالته سماوية العطاء أي أننا ننظر للسماء ومبدعها قبل تقديم عمل فني وقبل أن نراقب هذا العمل .. صعب صحيح لكنه مع المبدعين الحقيقيين ليس صعبا .
الإعلامية والكاتبة السعودية سماء الشريف ترى في مداخلتها أن :
الرقابة : خاصة داخلية ذاتية وهذه يقينا أنها الأقوى وهي قد يمكن اعتبارها من ضمن عوامل الإبداع الخاصة ويقينا تظهر في كل عمل كونها ثوابت داخلية في نفس المبدع أياً كان جنسه (الأدبي)
ولكن الرقابة الأخرى التي تُفرض لإجازة أو تقييم أي عمل :
ألا يستطيع المبدع تجاوزها حتى لاتكون عائقاً أمامه لاسيما وأنه بات يعرف كل أنواعهم الرقابية ؟
هناك من يستطيع بدليل أن هناك نصوصاً لم تمر على مقص الرقيب ولم ترفض أو تمنع .. فما السبب ؟..
أعتقد أن الكاتب يستطيع أن يتحايل أو يعتمد على ذكاءه وخبرته في تجاوز ذلك حتى يفلت بنصه من المنع أو التدخل
لأنه لايريد أن يتوقف يريد إيصال مالديه للآخرين بكل الوسائل المتاحة أمامه .
يظل السؤال :
خلال كل السنوات واكتساب العديد من الخبرات ومعرفة أنواع الرقابة وتدخلاتها وهمينتها في أحيان أخرى .. ألم يجد الكاتب المخرج .. أو المشتغلون بذلك بكافة أجناسهم حلاً ؟!
أم هو بكاء لعجز عن القدرة عن تجاوز مقص الرقابة وهيمنتها ؟!
أم عجز فعلي أمام قوة أكبر ؟
هناك اجتماعات ولقاءات وفعاليات أين ذلك من التقائها لوضع مقترحات وإيجاد حل
هل نقول أننا أضعف من تلك الرقابة ؟!
أم أننا نشتغل بهموم أكبر ولا وقت لدينا ؟!..
أم الأنا لاتترك وقتاً للهم الجماعي .. نصوصي مجازة .. إذا ليبحث الآخرون الحل ؟!
ليس الحل في تكرار الكتابة عن الرقابة ودورها بل في اعتقادي مهم جداً البحث عن الحل ولو كان بداية ننفذ منها
.
أما الكاتب المسرحي المغربي المختار العسري فهو يعتبر الفن عامة والمسرح على وجه الخصوص؛
من الأنشطة التي مارسها الإنسان لإعادة خلق الحياة، موظفا أساليب و وسائل مختلفة، ولذلك يعتبر شكلا من أشكال الوعي الفكري والاجتماعي، وقد تطور هذا النشاط الإبداعي شكلا ومضمونا، وذلك تبعا لتطور وعي الانسان بالعالم، هذا التطور الذي واكب تطور حياته الاجتماعية.
ويرى أن المسرح بما له من خصائص وإمكانات يعد في الحياة الفكرية، بما يحمله من قضايا الإنسان، وبما يتمثله من جدل الحياة في فكر البشرية ووجدانها، مبنيا عن رؤية ضميرها للحدث الماضي والحاضر والمستقبل، وللطبيعة المباشرة في عرضه وتلقيه، يصبح من الفنون ذات الحساسية لما يعتري المجتمع من تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية، بحيث تؤثر هذه العوامل في حركته وتطوره، وتنعكس ملامح تاريخه وعلاقته بالمجتمع على أدائه لدوره في تزويد الناس بالمعطيات الفكرية والفنية، إنسانية عاطفية، الأمر الذي يجعل المسرح – فضلا عن كونه فنا جامعا- مؤسسة ثقافية ترتبط بالمجتمع في حركته.
وبالتالي يتيح للإنسان تأمل واقعه ومصيره، وردود فعله ازاء الأحداث والوقائع، وتقييمها من اجل الخروج باقتراحات للحياة فكرا وممارسة لذلك، فالمسرح من الفنون التعبيرية، التي عبرت عن الإنسان وقضاياه، منذ زمن سحيق، وما الواقع الذي يصدر عنه إلا نقطة البداية ، لتوضيح التناقضات الاجتماعية، التي تأخذ منها عناصر اتهام للمجتمع، وعناصر دعوى الى التغيير.
و المسرحي باعتباره مثقفا فهو" يعرف أنه الكائن المحتج بالطبيعة، فما دور المثقف إن لم يكن هو الرفض والممانعة، النقد ومحاولة تقويم توجهات الناس واعوجاجات السلطة، ورسم المستقبل وتقديم ملامح العامة، فالرضى بالواقع ليس من خاصية المثقف، وخاصة ذلك القريب من المواطنين والمندمج في واقعهم والمطلع على معيشهم اليومي"
وهكذا يقف المسرحي /المثقف وسط العاصفة، فهو مطالب بالوقوف موقف عدم الرضى من الواقع، لذلك يصير مستهدفا ،من قبل السلطة طالما لا بعمل على الدعاية لها وصوغ موقفها، اذ المهم هو جعل المواطنين يقبلون بالواقع كما هو، في اطار نوع من الرضى. لذلك فمتى خرج عن هذه الدائرة صار من أعداء الدولة، وهذا ما يفسر السلوكات التي تنهجها ضدهم، من قمع وطرد من العمل وتوقيف وحجز للوسائل التعبيرية .
مؤكداً أن العيش في مجتمع بين تأثير وتأثر سيكون سبباً في أن يتحمل المثقف الفنان مسؤوليته التاريخية ،والا ستترك البلدان اما للجهل والتجهيل وغياب القانون والجميع نعلم ما يعانيه العالم العربي اليوم شعوب اتكالية ،لم تغيرحتى عاداتها وتسير الى تغيير ما حولها، مطالباً بالعمل المتواصل ليل نهار وتحمل المسؤولية في إيصال الفن والمسرح الى اكبر فئة في الفيافي وفي الجبال وفي كل الاماكن لتوعية الناس وهنا اكيد ستكون البداية في توسيع هامش الحريات لكن بشعوب واعية اذا ثارت او غضبت تعرف كيف تغضب وتثور
واختتم مداخلته بما يحدث في المغرب اليوم حيث قطع الفنانون شوطا كبيرا حين سلطوا الضوء على الكثيرالممارسات والقضايا التي تعتبر من الطابوهات المسيجة بسياج التحريم كالجنس والدين وايضا السلطة .
وكتب المسرحي الحبيب السوالمي من الجزائر عن الرقابة على المسرح في الجزائر :
حيث يرى أنها تختلف عن رقابة المسرح في دول الجوار مثل تونس والمغرب لأن في الجزائر لا يحدث ذلك وإن تم رفض نص مسرحي لأي سبب من الأسباب -وهذا راجع لطبيعة النظام المؤسس للفعالية المسرحية - فلا توجد هيئة رقابية تتحكم في إجازة العمل من رفضه .
فالنص المسرحي الجزائري على مستوى المسارح المحترفة له لجان قراءة تتعامل معه من الناحية الفنية ويتم إجازته أو رفضه لاسباب فنية وبكن لم يحدث أن رفض نص لمضمونه السياسي أو الفكري
أما بالنسبة للفرق المسرحية الخاصة فلها حرية إنتاج ما تشاء من أعمال ولكن النقطة الخطيرة في المسرح الجزائري هو أنه تم تمييعه وإبعاد المتلقي عن قاعات العروض فليقل المسرحي ما شاء ليس من يسمعه، بمعنى أن المتلقي لا يذهب الى المسرح ويهذا فإن المسرح لا يؤدي وظيفته
مستفسراً في ثنايا مداخلته : حول ذهاب المتلقي إلى المسرح في الوطن العربي ؟.. وما أثر المسرح على المتلقي من الناحية الفكرية والفنية ؟..
ويعتقد السوالمي من خلال متابعته للحركة المسرحية في الجزائر أن المسرح لا يعاني أزمة رقابة بقدر ما يعاني أزمة عزوف نظرا لتداخل مجموعة من الأسباب منها النص الدرامي نفسه الذي يفتقد لجمالية الإمتاع من ضمن ما يفتقد إليه وكذلك ظهور بعض الذين يحسبون على المسرح وسيطرتهم على الحياة المسرحية بطرق لا تمت للفن بصلة فميعوا المسرح حتى أضحى في نظر المتلقي العادي رديف للتهريج أما الرقابة على المسرح ففي الجزائر المبدع هو رقيب نفسه وخاصة فيما يتعلق بثالوث الدين والجنس والسياسة .
كنعان البني المسرحي السوري يرى أن المسرح ممارسة الحرية :
فالابداع برأيه صنع الجمال والأناقة بتنسيق من وعي معرفي مجتمعي إنساني يفسح المجال لتشكيل حالة تنمي الذائقة الفنية الجمالية عند الفرد . .مقدمة مكثفة مختصرة
كتب في مداخلته : "على أرض الواقع إلى أي مدى نقارب ما تم ذكره بما سبق ..طبعا لاشيء إلا بنسب متفاوتة كما ذكر بمداخلات الأحبة ..لكل منا تجربته مع الرقابة الذاتية المكرسة بالقمع والأناقة وإلغاء الآخر وهذا حال السلطات القمعية في بلداننا ومن شابه حالنا من البلدان الأخرى ..والرقابة الخارجية المنطلقة الكل ماهم حتى تثبت براءته ."
ويرى أنه على أن يكونوا أكثر وعيا ودهاءا من الرقيب .. مستخضراً كلام شيخ المسرح العربي المرحوم يوسف العاني الذي وصف وضع الرقابة من خلال تجربته بالعراق أن المبدع لايكون مبدعا إن لم يتغلب على الرقيب .
مشيراً إلى نص"المفتاح" للمرحوم نموذج لمثل هذه الحالة .
كما يرى أن الرقابة غير الفنية فعل غير أخلاقي .. مؤكداً أنه لارقابة على الفكر والإبداع ..
ويرى أن الرقابة ورثت الجميع سلوكا غير إنساني تحت شعارات وصلت حد جلد الذات ..
وختم مداخلته مؤكداً أن : كل المشاكل نتاج حالة ضعف الوعي الاجتماعي وقلة الحوار وعدم إتقانه لقلة الوعي به وعدم ممارسته كأسلوب حياة أفراداً وجماعات .
الممثل والمخرج السعودي ومؤسس محموعة المسرح ثقافة سامي الزهراني يرى في مداخلته أن الرقابة :
اسم يرعب الكثير من الكتاب والمؤلفين في المسرح، كما أن الرقابة المسرحية في الدول العربية تأتي على عدة مسميات ومن المستغرب أن في بعض الدول العربية هناك بعض النصوص المسرحية يتم فسحها من هيئات الرقابة المعنية ويتم منع عرضها بدوافع اخرى مختلفة من خلال لجان المشاهدة التي تسبق المناسبة التي سيتم العرض بها، وَمِمَّا يدعوا للاستغراب ما يحدث في بعض الدول العربية التي تستضيف عروضاً أجنبية تتحدث عن المحرمات الثلاث الدين ، الجنس، السياسة ويتم عرضها دون تعرض هذه العروض للرقابة .
مبيناً أنه من واجب المسرحيين جميعاً أخذ الأمر ( بنظرة إيجابية ) قليلاً ، وقد اتخذ من الرقابة في المملكة العربية السعودية مثلاً في ارتفاع سقف الرقابة بدرجة عالية جداً ، حيث أنه لا يتذكر - نظراً لقربه من بعض الكتاب -أنه قد تم رفض أي نص لهم .
مؤكداً أن الرقابة ساهمت كثيراً في تَخَلَّق نصوص إبداعية جميلة تناقش قضايا بطرق إبداعية مبهرة ومميزة أقدم عليها المؤلفون للتحايل فيها على الرقابة وجهلت المشاهد المسرحي ليس مجرد متلقي فقط وإنما شريك في اللعبة المسرحية من خلال تحليل النص للوصول إلى مقولة النص الرئيسة
كما يرى أن الرقابة خففت كثيراً من المباشرة الفجة لبعض النصوص وتركت الفرصة للإبحار في التحليل والنقد وفك رموز النص وأجبرت العديد من المؤلفين على زيادة مخزونهم الثقافي والمعرفي ليتزودوا بمعارف وطرق جديدة للتحايل على الرقابة .


وقد كان للمجموعة نقاش في برنامج الحوار المحدد لهذا الأسبوع حول ؛ "سقف الرقابة الكتابية .. التأليف المسرحي انموذجاً "
المشاركون في الحوار :
- الاستاذ الدكتور سيد علي اسماعيل من مصر .
- الناقد المصري د.محمود سعيد مشرف المجموعة .
- الناقده والكاتبه العمانية د.آمنه الربيع .
- مؤسس المجموعه المسرحي السعودي سامي الزهراني .
- الناقده المصريه د. لمياء أنور .
- المسرحي السوري د. عجاج سليم .
- المسرحي العراقي د. أحمد الشرجي .
- المسرحي السعودي عباس الحايك .
- الاعلاميه السعودية سماء الشريف مشرفه المجموعة .
- المسرحي العراقي د. جبار خماط .
- المسرحي السوري كنعان البني.
- المسرحي العراقي فرحان هادي .
- المسرحي السعودي حسن الخلف .
- المسرحي المغربي المختار العسري .
- المسرحي المغربي عزيز ريان .
- المسرحي الجزائري د.سوالمي الحبيب .

بداية المداخلات انطلقت من مداخلة الناقد المصري د. محمود سعيد الذي يرى أن :
الرقيب العربي لازال يمتلك عقلية غريبة قادرة علي الإثارة والدهشه والصدمه لدرجه اننا أصبحنا نحيا مرحلة المصادر ة والمنع وكأنها أصبحت
شهوة المنع والمصادرة لدرجه أن تحولت المصادره إلى داء عربي مزمن يصعب علاجه
ومن جانب آخر يرى أن الرقابه بكل أشكالها كانت وما زالت تعبيرا عن السلطه السياسيه مع ان المفروض ان تكون هي السلطه الثقافيه والفنيه التي تحكم الرقابه لا غيرها محدداً أنها ( فرضيه شديده الخصوصيه و الأهميه )
ويفسر رأيه في ذلك : "من العبث اننا نجد الرقابه لها دور قبل العمل وبعد تنفيذه بمعنى ان قرارات الرقابه قبل تنفيذ العمل في وادي وبعد العرض في وادي آخر"
مؤكداً أن : الرقابه باقية ما بقي المبدع ولكن :
العلاقه بين الرقيب والمبدع ستظل علاقه يشوبها اللغط وعدم الوعي خاصه ان الرقيب في الاغلب لا يكون فناناً أو حتى ممارس للفن لذا يطبق قوانين جامده بلا وعي أو روح أو حس
ويؤكد على أن الرقابه الذاتيه من المبدع ذاته حين يتحول المبدع الي رقيب على عمله
وعند الوصول لتلك المرحله بشكل صادق لن تكون هناك حاجة الى رقيب
وقد يلعب الناقد دور الرقيب في شكله السليم لو أجاد لعبته واتقن مفردات اللعبه المسرحية.
أما الدكتور سيد علي إسماعيل فيرى أن الموضوع مهم جداً بالنسبة له حيث أنه :
صاحب أول كتاب عربي في مجال الرقابة المسرحية وصدر من 20 سنة.. ولذلك أرفق رابطه ليكون فرصة ليطلع عليه الجميع :
رابط تحميله كاملا مشاركة مني في الموضوع
http://kenanaonline.com/users/sayed...ownloads/77276
الناقدة المصرية الدكتورة لمياء انور ترى أن الموضوع هام جدااا وشائك :
معللة ذلك : بأننا لسنا امام ظاهرة او قضية بقدر ما نحن عليه اليوم من ممارسات في اغلب الاحيان غير حيادية وغير موضوعية
وقد وجدت أن الرقابة للرقابة على ثلاث اشياء في العملية الابداعية وهما الدين والجنس والسياسة ، لذا جاءت الرقابة بمفهوم المنع وفي بعض الاحيان البتر لجزء من العمل الفنى دون الوعى بسير العملية الفنية لذا جاءت الرقابة لخدمة اهداف سياسية بالمقام الاول بعيدا عن الابداع في حد ذاته ومن هنا اصبحت علاقة الرقيب بالمبدع علاقة ادارية بحته الاول ينفذ دون وعى و الاخر تمارس عليه ضغوطا ليس لها علاقة بالفن
ومن ذلك ترى ؛ أن الرقابة ليس لها دور في اطار العمليه الفنية خاصة انها لا تناقش -مثلا -مايتناولة العمل الفنى من نظريات او اتجاهات حداثية او غيرها .....
وتتساءل من خلال ذلك :كيف يمكن المطالبة باعمال فنية وابداعية في ظل الرقيب والمنع والشجب.
مطالبة إطلاق العنان للفنان لأفكاره وتجاربه لإنتاج عمل فني ، وهناك العديد من النقاد لديهم القدرة لانتقاد العمل الفني بعد إنتاجه وبشكل علمى وأكاديمي واحترافي أيضا بعيداً عن سلطة الرقابة والرقيب.
ثم كانت مداخلة د. آمنة الربيع من عُمان التي تدور حول الرقابة.. كتبت متناولة تاريخ الحذف في ثلاث نقاط :
(1) الرقابة تتطور عبر العصور، بينما قانون المطبوعات والنشر لا يتطور.
كتبت عن تجربتها الخاصة سطوراً جاء فيها :
" لي مع الرقابة علاقة قديمة ومتفاوتة بدأت برفض نشر بعض مقالاتي في الصحافة في بداية الثمانينيات، ثم هدأ الوضع، وعاد المنع وتجدد بعد أحداث 2011م والاعتقالات التي طالت بعض المثقفين وغيرهم. لكن التدخل الكبير والأخطر هو التدخل في سير خطوط مسرحياتي، كأن تكتب لجنة القراءة والتقييم في تقريرها ملاحظات تطلب فيها تغيير عنوان مسرحية وتغيير أسماء بعض الشخصيات ذات الدلالات الدينية، وكان آخرها مسرحية (المعراج) لقد أزعجتني ملاحظات لجنة القراءة لأنها وضعتني وطبق عجة البيض في كيس واحد! وربما تدّعي هذه اللجنة وسواها أنها لا تمارس دورا رقابيا، وهذه إحدى دفوعاتها، لكن من يستطيع أن يجزم أن تقريرها لا يُعد وثيقة رقابية، طالما طلبوا فيه فعل (الحذف) ؟
وما يُعنيني هنا، أن تاريخ الحذف عريق وسحيق. ولكنه على كل الأحوال ليس أعرق من تاريخ الرقابة!
حسنا، كلكم تعرفون عظمة الملكة إليزابيث التاريخية، هل تتخيلون أن تلك العظمة يمكن أن يزحزها أو يُربكها أو يُقلقها مشهد مسرحي!!
يذكر يان كوت في كتابه شكسبير معاصرنا أن جميع طبعات مسرحية الملك ريتشارد الثاني إبّان حياة الملكة إليزابيث قد حَذفت مشهد التنازل عن العرش لأن المشهد على حد قوله (يكشف بفظاعة زائدة كيفية العمل في الآلة الكبرى، في تلك اللحظة بالذات التي كانت السلطة فيها تنتقل من يد إلى يد)! وهكذا جرى حذف المشهد وقياس فظاعته بعظمة الملكة إليزابيث!!
كيف نستطيع أن نتعرف على أشكال الحذف البشعة للنصوص التي مر بها التاريخ منذ عصر شكسبير وإلى اليوم؟ ليس حصريا في المسرح، بل وفي جميع وسائل التعبير الأدبية والفنية المتاحة. يبدو الجواب في غاية الصعوبة؛ لسبب وجيه يتمثل في أن فكرة الرقابة نفسها قد تطورت عبر العصور وفي جميع الحضارات الحية، وذلك انطلاقا من قاعدة أن الممنوع مرغوب، وكلما تطور الممنوع في مجتمع ما تطورت الرقابة، لأن الممنوع ينتعش على حاشية المسكوت عنه" .
وأكملت مداخلتها بالنقطة الثانية التي كتبت فيها عن العلاقة الطردية بين الأدب والرقابة والحذف :
(2) هناك عصافير تذهب تبحث عن أقفاص.
أن العلاقة بين الأدب والرقابة والحذف علاقة طردية. فكلما زادت جرعة الحرية في مجتمع ما (وهي عموما لا تزيد لكن هكذا نوهم أنفسنا) كلما ارتفعت حدة صوت الرقابة وقيودها وتطاولت ألسنتها. قد تنتشر وشاية من أحد أصدقاء مؤلف/ مؤلفة الكتاب، أو من المؤلف نفسه أن المخطوط يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، ووصول الوشاية إلى الجهة الرسمية كاف لمصادرة المخطوط تأديبًا لصاحبه! فيتم مصادرة المخطوط والمؤلف/المؤلفة يجدان ضالتهما في نشره بطبعات غير قانونية، أو في خارج الدولة، أو على المدونات الشخصية، فترتفع بذلك قيمة رصيدهما في سوق الكتاب، في حين أن مضمون المخطوط نفسه قد لا يساوي جناح بعوضة! فتتحقق شهرة المؤلف/ المؤلفة من حيث لا تتوقع الرقابة.
*في النقطة الثالثة والأخيرة كتبت عن :
(3) مفهوم الدولة والرقابة بمثابة قفص يبحث عن عصافير.
تاريخيًا يرتبط تاريخ الرقابة السيئ والحذف بتاريخ الاستيطان للبلاد العربية. ولكنه عربيا يعود إلى أزمان سحيقة أخرى. وتعلو سلطة الدولة فوق الجميع. فمن المرجح أنه كلما تعلقت المادة الإبداعية بالثالوث (الدولة والجنس والدين) أو أشارت إلى أحدهما أو ألمحت لمحة خفيفة كلما اختلفت الآراء بين صاحب المادة الإبداعية مع الجهة الرقابية من جهة، ومع القراء من جهة أخرى، فيصير القارئ رقيبا وقاضيا وكذلك الكاتب/ المبدع يتحول إلى رقيب مضاعف. إن مجرّد تفكير المؤلف بكتابة عمل أدبي يقترب من الثالوث يُعد بمثابة الخيانة.
الناظر إلى العلاقة التسلطية بين الدولة والرقابة يظهر له أن مفهوم الدولة أحيانا أكثر هشاشة وأقل تماسكا من مفهوم الرقابة. وإذا كانت المهمة الأساسية للدولة عند ماكيافيلي هي "الأمن لا الأخلاق والحرية"، فإنّ الفيلسوف هيجل ذهب إلى القول بأن "الدولة ضرورة أخلاقية وتجسيد للحرية"، بينما قال ماركس بأنها "أداة قمع ومصادرة للحرية، هدفها الحفاظ على الامتيازات القائمة للطبقة الحاكمة على حساب الأغلبية المحكومة المعدمة". أما الرقابة نقلا عن ماريو إنفليزي في كتابه الكتب الممنوعة فتعتبر "حكمة سياسية بالغة، وانعكاسا ودرعا لكل حكومة جيدة"، فأيهما يسبق الآخر: الدولة أو الرقابة؟ وأيهما يتطور أكثر وأسرع: الرقابة أو الدولة ؟ .
من جانب آخر كتب د.أحمد شرجي من العراق مداخلته عن المحرمات الثلاث :
"التابوهات الثلاث او المحرمات الثلاث والتي معمول بها في اغلب بلداننا العربية، ويمثلن جوهر وجود الرقيب، ولجنة الرقابة تعتمد ذائقتها كما هي لجان التحكيم في المهرجان، وهذا الوجود يكون محفّزا ومقرفا في ذلت الوقت، محفز اذا كان واعيا وذو عقلية واعية وعالية المهنية منا تساهم ملاحظاته بتطوير النص وإيجاد وسائل تعبيرية ورمزية يفتح بها باب التأويل على مصراعيه، ومقرف عندما يكون ليس له علاقة بالموضوع وفرض وجوده داخل اللجنة كطرف أمني او حزبي ويكتب تقريره عن النص والعمل، اذكر في العراق في زمن النظام السابق كان هناك شخص أمني يجلس داخل البروفات ويكتب تقاريره عن كل مايدور داخلها....لكن السؤال الجوهري ما جدوى وجود التابوهات الثلاث( الدين، السياسة، الجنس) ونحن نتحدث عنها بيومياتنا وأحاديثنا العامة احيانا، المسرح بدء احتفاء بالجسد، واوربا تطورت عندما فصلت الدين عن الدولة، التجربة الان في المسرح العراقي اكثر صعوبة، لعدم وجود اي رقيب سوى الرقيب الفني على مستوى العمل، ولعدم وجود التابوهات الثلاث كما في مسرحية يارب وستربتيز، زادت من صعوبة الموضوعة وكيفية معالجتها برؤية تبتعد عن المباشرة والتسطيح على المستوى اللفظي والبصري ، الفنان ليس ملح، ولا داعر ولا خطيب سياسي، الفنان مشاكس ومحرض لكل هؤلاء بطريقة جمالية بعيدة عن الاسفاف.
وحدد د. شرحي أن ماكتبه من واقع تجربة شخصية حين كتب مؤكداً : " اتحدث عن تجربة شخصية، في زمن النظام السابق، يرفض النص وتكتب عبارة ( غير صالح من ناحية السلامة الفكرية) وهذه العبارة حمالة أوجه ، ومازلت للان احتفظ بالنص ومكتوب عليه تقرير اللجنة ، بعد ٢٠٠٣ وبعد عودتي للعراق كنت ضمن لجنة المشاهدة في دائرة السينما والمسرح، رفضنا اكثر من عرض على المشاهدة من الناحية الفنية فقط، لسنا معنين بخطاب العرض الفكري فهذا خيار المخرج، وكنا نستدعي المخرج لوحده في قاعة اخرى ونتحدث أمامه بكل الملاحظات حتى لا نحرجه اما فريقه، بعضهم يرفض الملاحظات ولا يقبل التدخل بعمله، والبعض يأخذ ويتفق مع ملاحظات اللجنة ، وكما قلت في مداخلتي بان اللجنة كما لجان تحكيم تعتمد ذائقة أشخاص ، ولهذا اسميناها لجنة المشاهدة ومهمتها الرئيسة الجانب الفني فقط
لجنة المشاهدة، ونعمل تحت هذا العنوان لتقويم العمل الفني فقط، الاداء، الاخراج، التعامل مع النص، السينغرافيا وتوظيفها، اي، عيون اخرى مثقفة ومدربة من خارج التجربة قبل عرضها للجمهور، بالمناسبة هذه موجودة في أوربا ويسمى عرض تجريبي قبل الافتتاح الرسمي بأسبوع او اكثر ويكون الحضور بدعوات خاصة للصحافة ومن يختارهم المخرج، ويعطون ملاحظاتهم عن العمل.. وهذه ظاهرة صحية للارتقاء بالعمل المسرحي"
ويرى في ذلك أن : المشكلة الرئيسة عدم إجادة فن الحوار حتى اغلب من يدعون ذلك، يرى ما يطرحه هو الأصح دائما ، ويتهم الآخر بالجهل والفشل وعدم المعرفة إذا لم يتفق معه بالراي، ويرفض الحوار المعرفي .
وختم مداخلته بسؤال مما يحدث في كل ما أورد:
( وإلا فماذا نسمي هذا التخبط على مستوى التنظير والمصطلحات؟ )
المسرحي السعودي حسن الخلف يرى أن :
الرقابه بحد ذاتها تحتاج لرقابه ويعتقد أن الاعلام الرقابي لو أتيت بنص لفسحه ويتم فسحه رقابيا للعرض او النشر وبعد فترة وجيزة تأتي بنفس النص ولكن بعنوان آخر يتم فسحه بالعنوان الجديد وبكاتب جديد
الدكتور عجاج سليم من سوريا ينظر من زاوية أخرى حيث يستغرب من بدء النقاش باعتبار بدهية الرقابة :
يبدو أننا بدأنا النقاش وكأن وجود الرقيب مسألة بدهية في حياتنا الفنية والفكرية. لننطق أولا أن وجود الرقابة بالمعنى الموظف الإداري هو أمر غير طبيعي. لأن الإبداع دائما لا يصدر إلا عن روح حرة مشاكس تبغى كسر المألوف والتقليدية والعادية.
والإبداع رفيق التجديد والتجريب. الإبداع لا يعيش في الماضي. ولا يخضع لسلطة ..أي سلطة .
المبدع يعيش في بيئته ويعرف كل تفاصيل حياتها...وهو ضميره الحي. ..لذلك وجود رقيب غير الرقابة الذاتية التي تدرك حجم وسعة الفضاء الذي تعيش فيه..هو إهانة للكائن الحي الذي نطلق عليه اسم فنان أو مفكر.
الرقابة التي عانت منها اوربا في العصور الوسطى جعلت الانفجار والرفض عند المبدعين بحجم ثورة عالمية.
ونعرف نحن في الشرق نعاني وخاصة في المسرح نعيش رهاب الرقابة ونخصع لها...بإرادته أو غصب عنا. وهي لم تعد تقتصر على رقابة الموظف قاصر الرؤية. بل صرنا نخضع للرقابة الدينية ورقابة المجتمع...لذلك نحن ندور طولة في فنجان منذ قرون طويلة.
نحن ضحايا الخوف الذي زرعته أنظمة لا تحترم الفرد وعلى مستوى الشرق. وازعم أنني لا استثني. ..أحدا في الشرق.
الرقابة حالة قصور إنساني وعائق إبداعي تقف كالسد في وجه حرية الإبداع.
لا نستطيع تجاوزها حاليا ومباشرة .ولكننا نستطيع أن نتجاوزها بذكاء لا يستطيع الرقيب الموظف المتحجر.
بريخت استنكر أن يكون الشرطي الرقيب أذكى من الفنان المبدع...أي أن يكون قادرا على القبض على أفكار تسعى للحرية والعدالة واحترام الإنسان الفرد.
وقد اتخذ من مجموعة المسرح ثقافة مثلاً حين حدد ها ليدعم رأيه الذي حدده فيما كتب : "هنا في المجموعة الثقافية نحن نعيش مثل هذا المثال ولن يكون الرقيب ابرع منا في رغبتنا المستمرة لنشر وتبادل الأفكار .
الكاتب المسرحي السعودي عباس الحايك يرى أن علاقة الكاتب بالرقابة بطبيعتها علاقة ملتبسة :
وليست علاقة الكاتب المسرحي وحده، بل كل من يمارس شكلاً من أشكال التعبير أدباً كان أو فناً، ولنقل أكثر هي ملتبسة مع كل مبدأ وصاية، فالإنسان بطبيعته ينفر من الوصايات، ويتوق للتحرك بحرية دون عوائق.
الكاتب المسرحي بطبيعته ميال لأن يكتب بحرية مطلقة، يطرق ما يشاء من موضوعات دون وجل ودون وصاية أحد عليه، مع هذا فإن ثمة رقابة داخلية تبنيها الطبيعة الاجتماعية أو الانتماء لجماعة ما أو طبقة ما، أو حتى وجود ما. ثمة التزامات تنبني في اللاوعي وتتحول لوصاية لذاتية، أو لنقل رقابة ذاتية لا تحتاج لأي وصاية خارجية. لذا لا يجد الكاتب مطلق الحرية في الكتابة فثمة ما يعلق في ذهنه عن خطوط حمراء اجتماعية ودينية وأخلاقية تمنعه من الانطلاق.
المشكلة في الرقيب الخارجي الذي يتطرف في بعض الظروف تجاه هذا الكاتب ويمارس وصاية أشبه بقمع أفكار الكاتب ويحد من حريته حتى في الموضوعات التي يقاربها في نصوصه، وهذا وفقاً للمكان ووفقاً لطبيعة هذا الرقيب. وبطبيعة الحال سيحد هذا من إبداعات الكاتب لأنه سيجد نفسه في دائرة مغلقة وفي موضوعات محدودة يمكنه تناولها ولن يتمكن من تجاوز تابوهات الرقيب.
الجيد أن الرقيب العربي مثلاً ليس واحداً، ولا يستند لنفس المعايير، فما هو ممنوع في بلد قد يكون مسموحاً في آخر، العكس صحيح. فيمكن تمرير نص بسهولة في بلد ما بينما يتعثر هذا النص أماما مقص الرقيب فيمنع عرضه. لذا فإن على الكاتب في الوقت الحالي حين يكتب نصاً ملامساً لموضوعات حساسة فإنه يمكنه إخراج نصه من عقبة العرض بنشره على شبكة الانترنت ليجد طريقه على الخشبة في مكان ما حيث يكون الرقيب يعمل ضمن معايير أقل تعقيداً. وإن كان نشر النص محفوف بالمغامرة، في وقت أصبح المخرجون ينفذون النصوص التي يقرأونها من على الشبكة دون العودة للكاتب والحصول على موافقته.
لن تنتهي هذه العلاقة إلى خير دون أن يتخفف الرقيب من تطرفه تجاه ما تطرحه النصوص المسرحية، فالنص المسرحي مهما كانت محمولاته لا يمكنه أن يكون مؤثراً بالقدر التي تؤثر فيه وسائل التواصل المفتوحة والفضاء الافتراضي الذي لم يعد قادراُ على أي رقيب منع ما فيه. النص المسرحي بطبيعته نص إبداعي كاشف ولا يمكن أن يخاف منه كمحرض ليتعامل الرقيب معه بريبة.
الدكتور جبار خماط من العراق يرى أن الرقابة والإبداع لايلتقيان والسبب في ذلك :
أنهما حدي نقيض في الانتاج والتاثير ، تؤدي الرقابة السياسية او العرفية او الدينية او الاجتماعي ، الى نكوص ابداعي تعلو في الذاتية المعزولة عن حركة المجتمع ومتطلباته ، وثمة نتاج ادبي او فني ، يتمرد على الرقابة بالاستعارة الفنية الرمزية ، وهنا تكون رسالة الفن فوقية ونخبوية لا يتواصل مع الجميع ، ان الفن بذاته ، انساني القصد بوساطة الجمال الفعال المؤثر الخال من المؤثرات المقيدة للحركة الابداعية داخل العرض المسرحي المعافى تكوينا وتاثيرا ، فعلا الراقابة مازق كبير في بيئة تتطلب حرية كافية ومشروطة بالابداع الفني .
كما يرى أنه لا توجد رقابة ذاتية على الابداع ، لأنه طاقة ذهنية ابتكارية تتجاوز قيود الزمان والمكان بوصفها حدين تجرببين ، كما يقول الفيلسوف كانت ، بانه كيف له حدوده الخاصة ، وبالتالي لا توجد رقابة ذاتية ، لانها بمثابة قيد إضافي للقيود المفروضة على التجربة الفنية من الخارج ، ولنعلم ان الفن طاقة خلاقة لها خاصية الفرادة التي من ميزاتها الفرادة ، وهي لا تريد من المبدع رقابة ذاتية .
المسرحي عزيز ريان من المغرب تطرق إلى الرقابة بالمغرب التي يرى أنها تغيرت بشكل كبير :
ممثلاً لذلك بفترة التسعينات حين كانت فرقة مسرحية هاوية تتعرض لمضايقات عدة في اختيار النص حيث المقدم (عون سلطة أو ما يعرف بالشام بالمختار) هو من يؤشر على نص أو لا. فكان لزاما البحث عن اليات لللعب على الرمزية والابتعاد عن المباشرة.
فليس هناك هيئة خاصة بالرقابة بشكل رسمي كما بمصر مثلا لكن يمكن الضغط أو التضييق في ترويج وعروض النص أو المسرحية. فنشر نص مسرحي مثلا لا يمر برقابة رسمية تطالعه وتقبله أو ترفضه! لكن لو مَس (مقدسات) المملكة المحددة بالدستور سيتعرض صاحب النص لعقوبات زجرية! الا ان أسوأ رقابة هي رقابة المجتمع الذي قد يحاكم عرضا بشكل عادات أو تقاليد سبقت ويهاجمه بكل الطرق فقط لانه تجرأ وتعرض المسكوت عنه فلا يحاكم فنيا بل (اخلاقيا ) كما جرى مع عرض(ديالي) للمخرجة نعيمة زيطان!
متسائلاً :كيف سيتم تنظيم مجال الرقابة بالمغرب في مجال المسرح الذي لازال ينقش في الصخر طريقه؟
وكيف تراقب المنتجات الفنية وعلى اَي أساس ؟ فني؟ علمي؟ اجتماعي؟ نفسي؟ اخلاقي؟ ديني؟!!!!
ويؤكد من خلال ذلك : ان الكاتب ببلده يقوم بعملية رقابة ذاتية حيث يكتب وهو يستحضر ما هو ممنوع أو مجاز وهذا طبعا تضييق على حرية الإبداع ولا يعني ان قبول الاسفاف وماشابه لكن لابد من تقبل ماهو جديد وماهو صادم باعتبار قيمة المسرح التي تشارك قسرا في التغيير والتقدم.
كما يرى أن الثقافة لازالت كما في اغلب الدول العربية تعتبر زائدة دودية تم وراثتها من الماضي ولا ينظر اليها بشكل جدي وقيم وخصوصا فن المسرح الذي يعتبر فن تسلية ليس إلا.
ويختم مداخلته مؤكداً على ضرورة مناقشة الموضوع بين المهتمين وذلك لكي يقوم المسرحي نفسه برقابة منتوج المسرح بوازع فني وراقي أكثر ! .
المسرحي العراقي فرحان هادي كتب عن الرقابة في وطننا العربي حيث يرى أنها دائمة الاهتمام بالجانب السياسي :
ممثلاً لذلك بسؤال : هل يقصد المؤلف حكومة البلد أم يحاول المساس بالدين الحنيف دون النظر للأمور الفنية والإبداعية .. !
ومع ذلك لايرى مانعاً من نقد المؤلف حكومته ومسئوليه إذا قصد بذلك توجيها مباشرا أو غير مباشر ؟!..
مؤكداً أنه من تجاربه مع الرقابة :اهتمامهم بهذه النواحي مع الأسف الشديد وفي أحيان أخرى يفهمون المحتوى حسب رؤيتهم وفكرهم دون محاورة الكاتب .. موضحاً ذلك بمثال خاص حين قدم عملا للأطفال في بلد عربي وهو يحث على الاهتمام بالعلم وفي سياق العمل أن من يحكمهم لايحترم العلم والعلماء ولكنة حينما يمر بظرف مأساوي ولم يجد حلا إلا عند العلماء .. بعد ذلك يوصي بالإهتمام في العلم والعلماء .. قامت اللجنة برفض النص لأنه يمس الحاكم لهذه الدولة !!
ويؤكد في سياق مداخلته أنه ضد الرقابة ولكن بشرط أن تناقش المؤلف وليس المخرج فربما يقنعهم أو يقنعوه -الموضوع طويل وشائك - والرقابة الذاتية تحتاج لمؤلف صاحب ضمير حي ويحترم مهنته .. ولكن يوجد الكثير في وقتنا الحالي يكتبون للكسب المادي ...
ثم يختتم مداخلته حين يرى أن : النقاش مع المؤلف مهم وهنا حتى يتوضح للرقابة أيضا مايحمله هذا المؤلف من فكر نير .. ولكن نسينا أيضا أن ليس كل رقيب أيضا هو مهني .. هي إشكالية وكأن الهدف البحث عن المثالية بكل شيئ ومن وجهة نظره يرى أن الفن يجب أن تكون رسالته سماوية العطاء أي أننا ننظر للسماء ومبدعها قبل تقديم عمل فني وقبل أن نراقب هذا العمل .. صعب صحيح لكنه مع المبدعين الحقيقيين ليس صعبا .
الإعلامية والكاتبة السعودية سماء الشريف ترى في مداخلتها أن :
الرقابة : خاصة داخلية ذاتية وهذه يقينا أنها الأقوى وهي قد يمكن اعتبارها من ضمن عوامل الإبداع الخاصة ويقينا تظهر في كل عمل كونها ثوابت داخلية في نفس المبدع أياً كان جنسه (الأدبي)
ولكن الرقابة الأخرى التي تُفرض لإجازة أو تقييم أي عمل :
ألا يستطيع المبدع تجاوزها حتى لاتكون عائقاً أمامه لاسيما وأنه بات يعرف كل أنواعهم الرقابية ؟
هناك من يستطيع بدليل أن هناك نصوصاً لم تمر على مقص الرقيب ولم ترفض أو تمنع .. فما السبب ؟..
أعتقد أن الكاتب يستطيع أن يتحايل أو يعتمد على ذكاءه وخبرته في تجاوز ذلك حتى يفلت بنصه من المنع أو التدخل
لأنه لايريد أن يتوقف يريد إيصال مالديه للآخرين بكل الوسائل المتاحة أمامه .
يظل السؤال :
خلال كل السنوات واكتساب العديد من الخبرات ومعرفة أنواع الرقابة وتدخلاتها وهمينتها في أحيان أخرى .. ألم يجد الكاتب المخرج .. أو المشتغلون بذلك بكافة أجناسهم حلاً ؟!
أم هو بكاء لعجز عن القدرة عن تجاوز مقص الرقابة وهيمنتها ؟!
أم عجز فعلي أمام قوة أكبر ؟
هناك اجتماعات ولقاءات وفعاليات أين ذلك من التقائها لوضع مقترحات وإيجاد حل
هل نقول أننا أضعف من تلك الرقابة ؟!
أم أننا نشتغل بهموم أكبر ولا وقت لدينا ؟!..
أم الأنا لاتترك وقتاً للهم الجماعي .. نصوصي مجازة .. إذا ليبحث الآخرون الحل ؟!
ليس الحل في تكرار الكتابة عن الرقابة ودورها بل في اعتقادي مهم جداً البحث عن الحل ولو كان بداية ننفذ منها
.
أما الكاتب المسرحي المغربي المختار العسري فهو يعتبر الفن عامة والمسرح على وجه الخصوص؛
من الأنشطة التي مارسها الإنسان لإعادة خلق الحياة، موظفا أساليب و وسائل مختلفة، ولذلك يعتبر شكلا من أشكال الوعي الفكري والاجتماعي، وقد تطور هذا النشاط الإبداعي شكلا ومضمونا، وذلك تبعا لتطور وعي الانسان بالعالم، هذا التطور الذي واكب تطور حياته الاجتماعية.
ويرى أن المسرح بما له من خصائص وإمكانات يعد في الحياة الفكرية، بما يحمله من قضايا الإنسان، وبما يتمثله من جدل الحياة في فكر البشرية ووجدانها، مبنيا عن رؤية ضميرها للحدث الماضي والحاضر والمستقبل، وللطبيعة المباشرة في عرضه وتلقيه، يصبح من الفنون ذات الحساسية لما يعتري المجتمع من تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية، بحيث تؤثر هذه العوامل في حركته وتطوره، وتنعكس ملامح تاريخه وعلاقته بالمجتمع على أدائه لدوره في تزويد الناس بالمعطيات الفكرية والفنية، إنسانية عاطفية، الأمر الذي يجعل المسرح – فضلا عن كونه فنا جامعا- مؤسسة ثقافية ترتبط بالمجتمع في حركته.
وبالتالي يتيح للإنسان تأمل واقعه ومصيره، وردود فعله ازاء الأحداث والوقائع، وتقييمها من اجل الخروج باقتراحات للحياة فكرا وممارسة لذلك، فالمسرح من الفنون التعبيرية، التي عبرت عن الإنسان وقضاياه، منذ زمن سحيق، وما الواقع الذي يصدر عنه إلا نقطة البداية ، لتوضيح التناقضات الاجتماعية، التي تأخذ منها عناصر اتهام للمجتمع، وعناصر دعوى الى التغيير.
و المسرحي باعتباره مثقفا فهو" يعرف أنه الكائن المحتج بالطبيعة، فما دور المثقف إن لم يكن هو الرفض والممانعة، النقد ومحاولة تقويم توجهات الناس واعوجاجات السلطة، ورسم المستقبل وتقديم ملامح العامة، فالرضى بالواقع ليس من خاصية المثقف، وخاصة ذلك القريب من المواطنين والمندمج في واقعهم والمطلع على معيشهم اليومي"
وهكذا يقف المسرحي /المثقف وسط العاصفة، فهو مطالب بالوقوف موقف عدم الرضى من الواقع، لذلك يصير مستهدفا ،من قبل السلطة طالما لا بعمل على الدعاية لها وصوغ موقفها، اذ المهم هو جعل المواطنين يقبلون بالواقع كما هو، في اطار نوع من الرضى. لذلك فمتى خرج عن هذه الدائرة صار من أعداء الدولة، وهذا ما يفسر السلوكات التي تنهجها ضدهم، من قمع وطرد من العمل وتوقيف وحجز للوسائل التعبيرية .
مؤكداً أن العيش في مجتمع بين تأثير وتأثر سيكون سبباً في أن يتحمل المثقف الفنان مسؤوليته التاريخية ،والا ستترك البلدان اما للجهل والتجهيل وغياب القانون والجميع نعلم ما يعانيه العالم العربي اليوم شعوب اتكالية ،لم تغيرحتى عاداتها وتسير الى تغيير ما حولها، مطالباً بالعمل المتواصل ليل نهار وتحمل المسؤولية في إيصال الفن والمسرح الى اكبر فئة في الفيافي وفي الجبال وفي كل الاماكن لتوعية الناس وهنا اكيد ستكون البداية في توسيع هامش الحريات لكن بشعوب واعية اذا ثارت او غضبت تعرف كيف تغضب وتثور
واختتم مداخلته بما يحدث في المغرب اليوم حيث قطع الفنانون شوطا كبيرا حين سلطوا الضوء على الكثيرالممارسات والقضايا التي تعتبر من الطابوهات المسيجة بسياج التحريم كالجنس والدين وايضا السلطة .
وكتب المسرحي الحبيب السوالمي من الجزائر عن الرقابة على المسرح في الجزائر :
حيث يرى أنها تختلف عن رقابة المسرح في دول الجوار مثل تونس والمغرب لأن في الجزائر لا يحدث ذلك وإن تم رفض نص مسرحي لأي سبب من الأسباب -وهذا راجع لطبيعة النظام المؤسس للفعالية المسرحية - فلا توجد هيئة رقابية تتحكم في إجازة العمل من رفضه .
فالنص المسرحي الجزائري على مستوى المسارح المحترفة له لجان قراءة تتعامل معه من الناحية الفنية ويتم إجازته أو رفضه لاسباب فنية وبكن لم يحدث أن رفض نص لمضمونه السياسي أو الفكري
أما بالنسبة للفرق المسرحية الخاصة فلها حرية إنتاج ما تشاء من أعمال ولكن النقطة الخطيرة في المسرح الجزائري هو أنه تم تمييعه وإبعاد المتلقي عن قاعات العروض فليقل المسرحي ما شاء ليس من يسمعه، بمعنى أن المتلقي لا يذهب الى المسرح ويهذا فإن المسرح لا يؤدي وظيفته
مستفسراً في ثنايا مداخلته : حول ذهاب المتلقي إلى المسرح في الوطن العربي ؟.. وما أثر المسرح على المتلقي من الناحية الفكرية والفنية ؟..
ويعتقد السوالمي من خلال متابعته للحركة المسرحية في الجزائر أن المسرح لا يعاني أزمة رقابة بقدر ما يعاني أزمة عزوف نظرا لتداخل مجموعة من الأسباب منها النص الدرامي نفسه الذي يفتقد لجمالية الإمتاع من ضمن ما يفتقد إليه وكذلك ظهور بعض الذين يحسبون على المسرح وسيطرتهم على الحياة المسرحية بطرق لا تمت للفن بصلة فميعوا المسرح حتى أضحى في نظر المتلقي العادي رديف للتهريج أما الرقابة على المسرح ففي الجزائر المبدع هو رقيب نفسه وخاصة فيما يتعلق بثالوث الدين والجنس والسياسة .
كنعان البني المسرحي السوري يرى أن المسرح ممارسة الحرية :
فالابداع برأيه صنع الجمال والأناقة بتنسيق من وعي معرفي مجتمعي إنساني يفسح المجال لتشكيل حالة تنمي الذائقة الفنية الجمالية عند الفرد . .مقدمة مكثفة مختصرة
كتب في مداخلته : "على أرض الواقع إلى أي مدى نقارب ما تم ذكره بما سبق ..طبعا لاشيء إلا بنسب متفاوتة كما ذكر بمداخلات الأحبة ..لكل منا تجربته مع الرقابة الذاتية المكرسة بالقمع والأناقة وإلغاء الآخر وهذا حال السلطات القمعية في بلداننا ومن شابه حالنا من البلدان الأخرى ..والرقابة الخارجية المنطلقة الكل ماهم حتى تثبت براءته ."
ويرى أنه على أن يكونوا أكثر وعيا ودهاءا من الرقيب .. مستخضراً كلام شيخ المسرح العربي المرحوم يوسف العاني الذي وصف وضع الرقابة من خلال تجربته بالعراق أن المبدع لايكون مبدعا إن لم يتغلب على الرقيب .
مشيراً إلى نص"المفتاح" للمرحوم نموذج لمثل هذه الحالة .
كما يرى أن الرقابة غير الفنية فعل غير أخلاقي .. مؤكداً أنه لارقابة على الفكر والإبداع ..
ويرى أن الرقابة ورثت الجميع سلوكا غير إنساني تحت شعارات وصلت حد جلد الذات ..
وختم مداخلته مؤكداً أن : كل المشاكل نتاج حالة ضعف الوعي الاجتماعي وقلة الحوار وعدم إتقانه لقلة الوعي به وعدم ممارسته كأسلوب حياة أفراداً وجماعات .
الممثل والمخرج السعودي ومؤسس محموعة المسرح ثقافة سامي الزهراني يرى في مداخلته أن الرقابة :
اسم يرعب الكثير من الكتاب والمؤلفين في المسرح، كما أن الرقابة المسرحية في الدول العربية تأتي على عدة مسميات ومن المستغرب أن في بعض الدول العربية هناك بعض النصوص المسرحية يتم فسحها من هيئات الرقابة المعنية ويتم منع عرضها بدوافع اخرى مختلفة من خلال لجان المشاهدة التي تسبق المناسبة التي سيتم العرض بها، وَمِمَّا يدعوا للاستغراب ما يحدث في بعض الدول العربية التي تستضيف عروضاً أجنبية تتحدث عن المحرمات الثلاث الدين ، الجنس، السياسة ويتم عرضها دون تعرض هذه العروض للرقابة .
مبيناً أنه من واجب المسرحيين جميعاً أخذ الأمر ( بنظرة إيجابية ) قليلاً ، وقد اتخذ من الرقابة في المملكة العربية السعودية مثلاً في ارتفاع سقف الرقابة بدرجة عالية جداً ، حيث أنه لا يتذكر - نظراً لقربه من بعض الكتاب -أنه قد تم رفض أي نص لهم .
مؤكداً أن الرقابة ساهمت كثيراً في تَخَلَّق نصوص إبداعية جميلة تناقش قضايا بطرق إبداعية مبهرة ومميزة أقدم عليها المؤلفون للتحايل فيها على الرقابة وجهلت المشاهد المسرحي ليس مجرد متلقي فقط وإنما شريك في اللعبة المسرحية من خلال تحليل النص للوصول إلى مقولة النص الرئيسة
كما يرى أن الرقابة خففت كثيراً من المباشرة الفجة لبعض النصوص وتركت الفرصة للإبحار في التحليل والنقد وفك رموز النص وأجبرت العديد من المؤلفين على زيادة مخزونهم الثقافي والمعرفي ليتزودوا بمعارف وطرق جديدة للتحايل على الرقابة .






